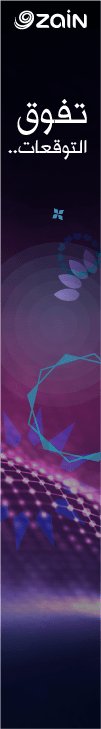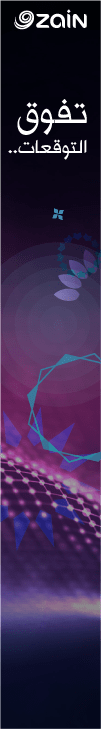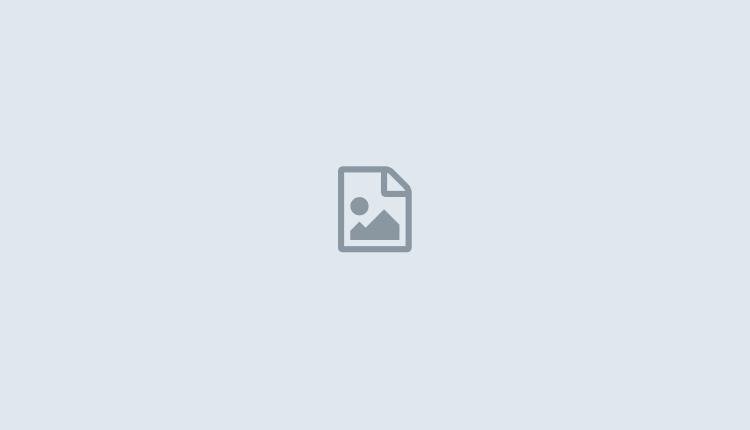رئيس الحكومة الذي يستحقه الوطن: خصاله… وآلية اختياره
تمكن الأردن ما بين عامي 1999 و2017، وبفضل رؤية قيادته الحكيمة وحنكتها وجهود نشامى الوطن ونشمياته الأوفياء المخلصين، من تحقيق العديد من الإنجازات الوطنية، كان من أبرزها الحفاظ على الوطن وكيانه وأمنه واستقراره ضمن محيط إقليمي يسوده الألم والدم والدموع، وتتلاعب به المؤامرات الدولية الهادفة لتفتيت دوله وتقسيمها وتدميرها وتشتيت شعوبها، وأطماع “عدو” جار لا يخفي قادته وفي كل مناسبة من إعلان هدفهم الأسمى بإنشاء دولتهم الكبرى من الفرات إلى النيل، ويتصيدون الفرصة لتحقيق هذا الهدف. هذا بالإضافة لتمكن الوطن، ورغما عن كل هذ التحديات الجسام، من الاستمرار في عملية التنمية الداخلية في القطاعات المختلفة من التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.
وبالرغم من هذه الإنجازات الوطنية الرئيسية والمحورية، إلا أن الأردن لم يتمكن من تحقيق العديد من الأهداف الوطنية الرئيسية الأخرى، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال العديد من مؤشرات الأداء الوطنية الاستراتيجية والتي من أبرزها ارتفاع مديونية الأردن من 7 مليارات دينار عام 1999 إلى أكثر من 30 مليار دينار عام 2017، وانخفاض مرتبة الأردن في مؤشر التنافسية العالمية من المرتبة 32 إلى 65، وانخفاضها ضمن مؤشر فاعلية الحكومة من 74% إلى 51% وفي مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من 76 إلى 118 (من أصل 190 دولة) خلال نفس الفترة، وغيرها من مؤشرات التنمية البشرية والتنمية المستدامة العالمية.
إثنا عشر رئيسا للحكومة شكلوا وعدلوا أكثر من أربعين حكومة تحمل أعضاؤها مسؤوليات تشاركية تضامنية داخل حكوماتهم، فاتخذوا ونفذوا قرارات إقتصادية واجتماعية، بعضها صحيح وبعضها غير ذلك، فنتج عنها ما نتج من إيجابيات وسلبيات.
ألقناعة الشعبية السائدة والصحيحة بأن الأمن والأمان الذي نعم الوطن به وما يزال، بفضل رعاية الله جل وعلا وفضله، مرده بعد ذلك القيادة الحكيمة والرصينة لجلالة الملك المعظم وتوجيهه لدفة مركب الوطن دوما نحو بر الأمان، والتفاف الشعب بكافة فئاته حولها، إضافة للعين الساهرة واليقظة للجيش العربي والقوى الأمنية والذين فدوا الوطن بدمائهم رخيصة في سبيل الحفاظ على ثراه الطاهر وحماية شعبه العظيم من كل مكروه…. وما زالوا يفعلون…
يتبقى “عدم النجاح” في تحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، والتي عانى الوطن منها وما زال، فأرهقت شعبه الطيب واستنفذت معظم قدرته على تحملها، وستبقى آثارها السلبية لأجيال قادمة ما لم يتم تصويب المسار بأسرع وقت. فالأمر لا يحتاج لخبير اقتصادي متمرس ومتمكن ليرى أن الأمور، ومنذ سنوات، تنتهج نمطا إقتصاديا واجتماعيا سلبيا. فإذا ما أردنا أن نصحح المسار فانه لا بد لنا من وقفة مصارحة، قد تكون مؤلمة – فالحقيقة لا تخلوا أبدا من الألم – ولكنها ضرورية. نشترك فيها جميعا لتحديد مواقع الخلل، دون إساءة أو تجريح، فنقر أولا بأن النهج السابق، بالرغم من بعض النجاحات المتحققة، لم يكن فعالا بمجمله، لأن الاعتراف بالمشكلة والخطأ وعدم المكابرة فيها لهو أول خطوة في حلها، ومنثم تحليل الأسباب ورائها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة والناجعة لها.
فهل السبب الحقيقي وراء التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي عانى منه الوطن خلال السنوات الماضية هم رؤساء الحكومات الذين يتم اختيارهم (والذين جلس بعضهم على كرسي الرئاسة لسنوات)، وذلك من منظور قواعد القيادة والإدارة الرشيدة والتي تقر بأن القيادة الحكومية تتحمل أولا وآخرا مسؤولية نتائج الحكومة التي تترأسها. أم أن السبب يكمن في الوزراء الذين يتم اختيارهم ومدى كفاءتهم وأهليتهم وعملهم بروح الفريق الواحد وبما يتواءم مع رؤية سيد البلاد وتوجيهات رئيس حكومته. أم أن الخلل في الجهاز الحكومي وبيروقراطيته وأساليب عمله والتي يشوبها في كثير من الأحيان التعقيد وعدم الشفافية، وتفوق قدرة أية حكومة على إصلاحها وتطويرها. ذلك إضافة لتنفيذها من قبل موظفين حكوميين غير مؤهلين أو مدربين أحيانا أو غير محفزين وممكنين لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين بما يلبي ويفوق توقعاتهم ومتطلباتهم ويحقق سعادتهم أحيانا أخرى.
أم أن المشكلة تكمن في السلطة الرقابية وعدم تمكنها لغاية الآن من تفعيل دورها الرقابي على النحو الأمثل وبما يضمن الأداء الكفؤ والفعال للحكومة بما يمكنها من تحقيق الأهداف الوطنية بكل فعالية وكفاءة.
أم أنها منظومة التشريعات والسياسات الوطنية التي يضعها ويقرها كل هؤلاء فتشكل الإطار المحكم لعمل الحكومات المتعاقبة بغض النظر عن شخوص رؤسائها وأعضائها ومؤهلاتهم وقدراتهم القيادية.
أو هل يكون السبب ثقافة مجتمعية يشوبها أحيانا التضارب والتناقض. ثقافة تبغض الفساد وتهاجمه دائما، ولكنها تتزلف للفاسدين المفسدين وتوجبهم وترفع من شأنهم في كثير من الأحيان. ثقافة تكره الظلم وعدم المساواة وتطالب جهارا نهارا ومن على كل منبر بتحقيق العدالة والمساواة بين افراد الشعب الواحد، ولكنها وبنفس الوقت تلجأ دوما للوساطة والمحسوبية في تسيير أمورها الحياتية اليومية، وذلك لقناعتها بأن ثقافة الظلم وتجاوز الحقوق قد تجذرت وسادت وأصبحت هي الأصل لا الإستثناء، ففقدت بذلك الأمل بأن هكذا عدالة ومساواة يمكن تحقيقها.
أم ان الخلل يكمن فيها جميعا وبنسب متفاوتة، فبناء الوطن، كما هدمه لا قدر الله، هو مسؤولية الجميع يشترك أبناء الوطن فيه جميعا غنما أو غرما.
إذا أين يكون البدء بالإصلاح؟؟!! أيكون ب “رؤساء الحكومات” ومعايير وآلية انتقائهم (قمة الهرم الحكومي)، أم يكون ب “الثقافة المجتمعية” (محيطه) وآليات تطويرها والارتقاء بها. فبالرغم من أن أية عملية جادة للإصلاح يجب أن تتناول كافة مستويات منظومة الهرم الإداري في الدولة وبشكل شمولي، إلا ان الإصلاحات الهيكلية يجب أن تبدأ دوما في القمة، فإذا صلحت القيادة الحكومية انعكس هذا الإصلاح على كافة المستويات الإدارية التي تدنوها.
إذا فمحور العملية الإصلاحية ونقطة بدايتها تكون في شخص رئيس الحكومة الذي يتم اختياره وصفاته ومؤهلاته وقدراته والتي إما أن تكون عاملا ذا فاعلية لإنجاز مهامه بنجاح، أو أن تكون وبالا على الوطن وعليه في حال عدم مواءمتها ومناسبتها لمتطلبات الوظيفة الحكومية الأرفع. ست خصال قيادية يجب أن تجتمع جميعها، وليس بعضها، لتجعل من رئيس الحكومة قائدا ناجحا يرتقي بعمله وانجازاته لرؤية سيد البلاد وتطلعات وامنيات الشعب وطموحاته المشروعة بالعيش الهانيء الكريم إذا ما توفرت، أو أن يكون مصدر إحراج وغضب القيادة التي اختارته وحنق الشعب في حال عدم توفرها. هذه الخصال، وبالرغم من وجوب تحققها وتوفرها جميعا في شخص الرئيس المكلف، إلا أنها ووفقا للأهمية والأولوية تكون:
أولا: النزاهة والاستقامة ونظافة اليد.
ثانيا: الانتماء والإخلاص والوفاء الحقيقي (وليس المصطنع والمزيف) للوطن وقائده وشعبه.
ثالثا: توفر الرؤية الواضحة للرئيس المكلف حول ما يريد القيام به لرفعة الوطن خلال السنوات الأربعة القادمة بما يحقق رؤية سيد البلاد وطموح وآمال وتطلعات الشعب.
رابعا: المهارات القيادية والشخصية المثلى من الرجولة والشجاعة والجرأة في قول الحق وفعله (مهما عظمت الضغوط)، ومهارات الاتصال والتواصل مع كافة فئات المجتمع وسعة الصدر والتواضع، والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة وفي الوقت الملائم دون أي تخبط أو تردد.
خامسا: المعرفة والخبرة الكبيرتين والقدرة على التفكير الإبداعي خارج الصندوق، وذلك ليتمكن الرئيس المكلف من الخروج بحلول تدفع باتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لا أن يقتصر عمله على اللجوء للحلول السهلة وانتهاج خط سابقيه من تحميل المواطن الحمل الأكبر لأخطائه وحكومته وسابقيها من الحكومات.
وسادسا: التقبل والثقة الشعبية (وليس فقط النيابية) والتي تمكنه بدورها من إدارة دفة حكومته وتوجيهها لاتخاذ القرارات الصائبة مهما صعبت، لأنها ستجد حينها تفهما شعبيا لها إذا ما استندت لمنطق سليم وواضح من مرجع ومصدر موثوق شعبيا. هذا التقبل وهذه الثقة والتي تنتج عادة عن الخصال الخمسة الأخرى في حال توفرها في شخص الرئيس المكلف. خصال ستة يجسدها بشمولية وبساطة ووضوح قوله تعالى: “إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين”.
ولنا في التاريخ الوطني لشخص الشهيد وصفي التل مرجعا معياريا وطنيا نموذجيا لشخص رئيس الحكومة الذي تحققت فيه كافة الصفات أعلاه، لا بل سعى رحمه الله وتأكد أيضا من تحلي كل من يختاره للعمل معه بها. فنال على إثر ذلك ثقة القيادة وحب واحترام الناس، فسطر اسمه في الذاكرة الوطنية لتبقى لنا نبراسا خالدا نهتدي به أبد الدهر.
أعتقد جازما بأن كافة رؤساء الحكومات الذين تم اختيارهم خلال السنوات الثمانية عشر السابقة يتحلون بواحدة أو أكثر من هذه الخصال الستة وبنسب متفاوتة (النزاهة والاستقامة والنظافة، الانتماء والولاء الحقيقي غير المصطنع، توفر الرؤية والمهارات القيادية والشخصية، والمعرفة والخبرة والتفكير الإبداعي الخلاق، والثقة الشعبية)، إلا أن المشكلة الأساس تكمن في أن عددا محدودا جدا منهم كان قد تحلى وتمتع بها جميعا، وهو الأمر والشرط الأساس لضمان قيادة حكومية فعالة وكفؤة. فهناك من كان يتسم بالجرأة على اتخاذ القرار في وقته مهما كانت صعوبته، إلا أن هذه الجرأة تحولت إلى غرور وثقة مبالغة فيها مع مرور الوقت، فتم تجاوز الدستور ومخالفة القوانين بصلف، بالإضافة إلى شبهات الفساد المالي والإداري والأخلاقي التي شابت هؤلاء طوال حياتهم وخلال فترة قيادتهم للحكومة، والتي كانت جميعها سببا للإطاحة بهم في نهاية المطاف. أسباب كانت تستوجب استبعادهم من تبؤ هكذا منصب منذ البداية. فالأدلة والاثباتات والبراهين على الفساد تكون مبررا للتحويل للقضاء والمحاكمة، أما شبهات الفساد بأشكاله المختلفة، وخاصة إن أصبحت إجماعا مجتمعيا على شخص ما، يجب أن تكون مبررا كافيا لاستبعاده من المواقع القيادية العامة.
ومن كان منهم يتحلى بالخبرة والمعرفة الطويلة وقدرا عاليا من النزاهة، إما أن يكون مفتقرا لسعة الصدر ولمهارات الاتصال والتواصل الرسمي والمجتمعي بكافة شرائحه، أو أن يكون ضعيفا ومترددا ومتخبطا، فيتخذ القرارات يوما وينقضها في اليوم الذي يليه. وآخرين كانوا يملكون من الخبرة الحكومية الشيء الكثير، ولكن أخذ عليهم تلونهم وانتهازيتهم وتقلبهم وسهولة تغييرهم لما كان يعتقد أنها مبادئهم ووفق ما يمليه عليه الموقف. فأخذ عليهم صلفهم في قلب الحقائق و”عدم قول الحقيقة”، حتى أمام سيد البلاد. كما أخذ عليهم محدودية أفقهم وعدم تمكنهم من التفكير الإبداعي الخلاق لدفع عجلة التنمية الاقتصادية قدما، بالرغم من خلفيتهم الاقتصادية، واقتصارهم على الحلول السهلة باللجوء لجيوب المواطنين، كغيرهم من معظم الرؤساء الآخرين…. أما أولئك والذين كانوا الأقرب للتحلي بمعظم الصفات والخصال القيادية المطلوبة أو جميعها، فإن “القدر” لم يمهلهم طويلا في قيادة حكوماتهم لسوء حظ الوطن.
فإذا ما تم اختيار رئيس حكومة من قبل جلالة الملك المعظم يحمل كافة هذه الصفات الستة (النزاهة والاستقامة والنظافة، الانتماء والولاء الحقيقي غير المصطنع، توفر الرؤية والمهارات القيادية والشخصية، والمعرفة والخبرة والتفكير الإبداعي الخلاق، والثقة الشعبية)، وليس أحدها أو بعضها، وتمكين ذلك الرئيس من ممارسة “ولايته العامة” دون تدخل أو ضغوط، فإن ذلك سيكون بداية الحل.
ألبعض يؤمن بأن الأمر لا يتعلق بشخص الرئيس أو مؤهلاته وانما بالسياسات الحكومية. ولذلك فإنه لا يهم من يأتي كرئيس للحكومة إذا لم تتغير هذه السياسات. وعليه فإن كل الرؤساء، بغض النظر عن قدراتهم ومؤهلاتهم وخصالهم، سواسية. لا يقدمون ولا يؤخرون. ولكني لا أتفق مع هذا الطرح، كون أن السياسات يضعها ويقرها ويطبقها قادة. فالقادة الحكوميون “السيئون” يضعون سياسات “سيئة” وينفذونها بشكل “سيء”، فتأتي عواقبها وبالا على الوطن والمواطن. والسياسات الناجعة، ذات الأثر الإيجابي على الوطن والمواطن، يضعها قادة أكفياء قادرون ومؤهلون. فالسياسة الوطنية هي المُخرج لعمل القادة، إن صلحوا صلحت، وإن فسدوا فسدت.
وألبعض يطالب بتعديل الدستور ليسمح بالانتخاب المباشر لرئيس الحكومة، وإخرون يطالبون بتشكيل الحكومات النيابية الآن، وأنا لست مع أي من هذين التوجهين في الوقت الحاضر أيضا. ففي ظل قوانين الانتخاب المعمول بها والثقافة المجتمعية السائدة حاليا فإن أي من النهجين سينتج عنه برأيي حكومات (رؤساء وأعضاء) تنتمي لأحد المذاهب الثلاثة التالية: رأس المال السياسي أو الفئوية والعصبية الضيقة أو العاطفة الدينية، والتي لن ينتج عن أي منها بالضرورة من يتحلون بكافة الصفات القيادية الضرورية للحكم الرشيد، فيبقى الوطن يدور حول نفسه وفي نفس الحلقة المفرغة ولسنوات طوال قادمة، ينتظر الفرج ولا يعلم كيف ومتى يجيء. كما أني لست مع إبقاء آلية الاختيار كما هي وكانت عليه للعقدين السابقين لأنها أثبتت عدم فاعليتها. فالاختيار وفق المعرفة الشخصية المباشرة أو تنسيب “البطانة” (الصالحة افتراضا) أو حتى استطلاع آراء النخب السياسية والتكتلات النيابية فقط، كما هو معمول به لغاية الآن، لم ينتج عنه اختيار رئيس حكومة يرتقي بأدائه لرؤية قائد الوطن وتطلعات شعبه. فكيف يمكن ل “بطانة”، يرى كثيرون بأن بعض رموزها لا يتحلون بالصفات القيادية المطلوبة، بأن تنسب لسيد البلاد من يتحلى بها؟؟؟!!! حيث يكون الهم الأكبر لهذا “البعض” حينها تنسيب من يعتقدون بأنهم يستطيعون “التعامل معه” بما يحفظ مكتسباتهم ولا يهدد نطاق نفوذهم وسيطرتهم. أو نخب سياسية وتكتلات نيابة تحاول جاهدة إدارة بوصلة القيادة نحوها لتحقيق مزيد من المكتسبات دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية الشاملة.
” من أين آت بقيادات حكومية كفؤة؟!… هل يجب علي أن أبحث عنها في المريخ؟؟!!”… صرخة مدوية أطلقها جلالة الملك المعظم قبل أشهر مبديا امتعاضه الشديد من أداء حكومته في ذلك الوقت، ومن خيبته من الفشل المتكرر للحكومات المتعاقبة… رؤساء ووزراء… والجواب على استفسار سيد البلاد يكون ب “لا سيدي… فلا حاجة للبحث عنهم في المريخ… فوطنك، مدنه وقراه وريفه وباديته، من أقصاه لأقصاه لهو مليء بالرجالات الأوفياء المخلصين. ومؤسسات وطنك سيدي، مدنية وعسكرية، عامة وخاصة، وجامعاته ومؤسسات مجتمعه المدني لهي حبلى بالرجال والنساء الأكفياء والذين يشهد بكفاءتهم القاصي والداني”… المشكلة تكمن في آلية التنسيب بمرشحي رئاسة الحكومة لسيد البلاد من قبل “بطانة” قد يعمد بعضها لحجب كل من يتحلى بالصفات القيادية المطلوبة حفاظا على مكتسباتهم ونطاق نفوذهم.
ولإطلاق عملية إصلاح شاملة وفاعلة تبدأ بقمة الهرم الحكومي وموقعه الأرفع، فإنه من المقترح تشكيل “لجنة ملكية خاصة ” برئاسة سمو رئيس مجلس السياسات الوطنية وعضوية عدد محدود من رؤساء حكومات وقضاة سابقين مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والحكمة والحيادية، تكون مهمتها الرئيسية تحديد المعايير الواجب توفرها بشخص رئيس الحكومة، وتقوم بالتواصل مع كافة المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لترشيح من تراه مناسبا لتبؤ المنصب الحكومي الأرفع وفق هذه المعايير، ومنثم تقوم بدراسة هذه الترشيحات للتأكد من انطباق كافة المعايير (وليس بعضها) عليها. ويمكن لها مقابلة مرشحي الرئاسة هؤلاء للاطلاع على رؤيتهم المستقبلية في كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الوطن خلال السنوات القادمة، كما يمكنها أن تقوم بالاستعانة بمراكز استطلاع متخصصة لقياس مدى التقبل الشعبي لهذه الخيارات، لتقوم بعد كل هذا برفع تنسيباتها بثلاثة إلى خمسة مرشحين للرئاسة لسيد البلاد لاختيار من يراه مناسبا منهم. على أن تتم العملية برمتها بشفافية ووفق مواقيت محددة وباطلاع الشعب على كافة مراحلها وتفصيلاتها.
بالرغم من كون النهج المقترح أعلاه لترشيح رئيس الوزراء غير تقليدي و”خارج الصندوق”، إلا أن فيه فوائد وميزات كثيرة على النهج المتبع حاليا. في كونه يوسع من قاعدة الترشيحات للمنصب الحكومي الأرفع لتشمل كافة المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني (وليس فقط تنسيب “البطانة” وتكتلات مجلس النواب). كما أنه يعزز من مصداقية ونزاهة عملية الترشيح ومأسستها من خلال لجنة ملكية يرأسها سمو رئيس مجلس السياسات الوطنية وعضوية عدد محدود من الحكماء المشهود لهم بالنزاهة والحكمة والاستقامة، ليضعوا معايير واضحة واجب توفرها في شخص الرئيس المكلف والتأكد من انطباق هذه المعايير على المرشحين للرئاسة قبل تنسيبهم لجلالة الملك المعظم، وهذا من شأنه الحد من إمكانية قيام “بطانة” قد يكون بعضها غير صالح بحجب الصورة الكلية عن سيد البلاد. علاوة على أن هذا النهج يعزز من شفافية عملية الترشيح والاختيار أمام الشعب، ويفتح المجال لهم لبيان رأيهم ورضاهم عن هذه الترشيحات قبل رفعها للمقام السامي. هذا كله بالإضافة إلى أن النهج المقترح لا يتعارض مع احكام المادة 35 من الدستور والتي تنيط صلاحية “تعيين رئيس الوزراء وإقالته وقبول استقالته” لجلالة الملك المعظم. فدور اللجنة الملكية يكون فقط بحصر الترشيحات ودراستها والتنسيب لجلالة الملك المعظم لاختيار من يراه مناسبا منها استنادا لصلاحياته الدستورية. مقترح خارج عن المألوف ولكنه يمكن أن يكون فاعلا في حال تطبيقه وبشكل محكم، ويمكن أن يشكل مرحلة انتقالية لحين تهيأة المناخ الملائم لتشكيل الحكومات النيابية.
رئيس الحكومة الذي يستحقه الوطن هو شخص قدوة أنموذج، عنوان في النزاهة والاستقامة والشرف ونظافة اليد. تشهد عليه بذلك خدمته الطويلة للوطن وقائده وشعبه، ويشهد عليه بها كل من عرفه وسمع عنه. إنسان إنتماؤه ووفاؤه وولاؤه واخلاصه للوطن وقائده وشعبه صادق ونقي وطاهر، لا زيف فيه أو تصنع أو تلون أو انتهازية أو رياء. لديه الرؤية الواضحة والمحددة لكيفية النهوض بوطنه اقتصاديا واجتماعية. يملك من القوة وألجرأة والشجاعة ليقول ما يفكر به، ويفعل ما يعتقد أن فيه خير الوطن والمواطن، دون خوف أو ضعف أو تردد أو تخبط، مهما بلغت الصعوبات والضغوطات. هو شخص يملك من المعرفة والخبرة والقدرة على التفكير الإبداعي ما يمكنه الإتيان بحلول جديدة خلاقة وناجعة تحقق التنمية المستدامة فيتحقق بها رخاء الوطن وسعادة المواطن. هو رئيس إنساني مفوه يستطيع الاتصال والتواصل بفاعلية مع المجتمع بكافة فئاته وشرائحه. رئيس حاصل على تقبل الشعب وثقته بما يقول ويفعل، فيتمكن من خلال هذه الثقة بأن يقود المركب الحكومي بنجاح في خضم تحديات داخلية وخارجية هائلة… والأردن، مدنه وقراه وريفه وباديته، لمليء بالنشامى والنشميات الذين تتجذر فيهم كافة هذه الخصال وتسري فيهم مسرى الدم في العروق.
فالأردن يستحق ذلك وأكثر منه بكثير….
حفظ الله الأردن عزيزا وقويا ومنيعا… وحماه شعبا وأرضا وقيادة…