التحول الديمقراطي الأردني بين وجهات نظر ووجهات وطن
لا بأس، بل ضروري وحيوي أن نختلف في وجهات النظر. ولكن لنتفق على أن خطاب الكراهية والبحث عن عدو داخلي لن يحمي الوطن. وحدتنا فقط هي التي ستحميه، فلنختلف في وجهات النظر ونتفق في وجهة الوطن ونسير معاً نحو مئويتنا الثانية.
المقالان السابقان طرحا موضوعين يتعلقان بالشباب: الأول أن الشباب الذي يمارس المواطنة الفاعلة ويشارك في الحياة السياسية ويواجه تحديات جمّة على أرض الواقع هو وسيلتنا الوحيدة للتحول الديمقراطي الذي يطال ليس فقط التشريعات وإنما الممارسات أيضا.
الثاني أن غالبية مواطنينا وشبابنا ليسوا منخرطين في الحياة العامة السياسية والاقتصادية، هذه “معضلة الثلثين” الموثقة والخطيرة والمتنامية. فالتحول الديمقراطي بات ضروريا والوقت ليس في صالحنا.
ولكن التحول نحو ماذا وكيف؟ هذا ما سيطرحه المقال الثالث، متناولاً ركائز الدولة الديمقراطية الناجزة، وطروحات الأوراق النقاشية التي تمثل الخصوصية الأردنية، وهواجس وتخوفات مشروعة حول التحول الديمقراطي.
محصلة هذه المقالات الثلاث أن فرصتنا وتحدينا الأكبر هو جيل الشباب. هذا المخزون الشبابي سوف يولد طاقات هائلة من الابداع والإنتاج والقدرة على حل المشكلات. ولكنه لا سمح الله سيولد طاقات هدامة إذا بقي موصداً.
نعم من الضروري التعامل مع التخوفات ولكن الخطر الأكبر يتمثل بأن نراوح مكاننا أمام تحديات محلية وإقليمية ودولية متراكمة.
فلنبدأ بمفهوم “الديمقراطية الناجزة. بالطبع لكل دولة خصوصيتها في مسارها. ولكن هناك توافق عام على ركائز الدولة الديمقراطية الناجزة: الدولة القوية، المجتمع القوي، والديمقراطية الحية المُمارَسة.
والدولة الديمقراطية الناجزة تصبح أيضاً ديمقراطية راسخة مع تداول السلطة بين الفرقاء بشكل سلمي ووفق قواعد العملية السياسية الديمقراطية.
الدولة القوية متطلب رئيس لأي تطوير نحو الديمقراطية الناجزة والراسخة. ولكنها ليست الدولة المستبدّة ولا دولة الحزب الواحد. صُلب الدولة القوية هو “سيادة القانون”، وليس فقط على المواطنين وبالتساوي ولكن أيضا على مؤسسات وأجهزة الدولة كافة. فلا أحد فوق القانون. والدولة بسلطاتها الثلاث ومؤسساتها تدير الشأن العام بتكامل واقتدار، فلا تغول من سلطة على أخرى.
والمجتمع القوي أيضا متطلب رئيس، ولكنه ليس المجتمع الذي يتطاول على القانون، وليس المجتمع المتفكك بهويات فرعية غير قادرة على التكامل والتناغم تحت مظلة الدولة والدستور والقانون. المجتمع القوي مكون من مواطنين متساوي الحقوق والواجبات، قادرين على مساءلة مؤسسات الدولة على أدائها ومشاركين في الحياة العامة كأفراد وكمؤسسات أهلية ومدنية وسياسية.
أما الديمقراطية الحية الممارسة فهي الوسيلة للتوصل الى التوافق وادارة الخلاف، ولكنها ليست صندوق اقتراع، ولا ديمقراطية شكلية هشة ومحسومة النتائج. إنها الديمقراطية التي تتيح للمواطن خيارات متعددة، وبمشاركة واسعة، لانتقاء ممثليه على المستوى المحلي وممثليه في السلطة التشريعية بغية الوصول الى حكومة برلمانية تحمل برنامج تنموي تنفيذي قابل للقياس والمساءلة والمحاسبة. ولا دولة ديمقراطية راسخة بلا تداول للسلطة بين مرحلة وأخرى، وإلا أضحت ديمقراطية شكلية لتجميل حكم الحزب الواحد.
ليس هناك وصفة جاهزة، ولكل تجربة ديمقراطية خصوصيتها، وهكذا هي تجربتنا الاردنية. فما هي خصوصيتنا فيما يتعلق بالوجهة، والتي تتطلب وفاقا وطنيا واسعا؟ وما هي خصوصيتنا فيما يتعلق بالطريق ووتيرة المسير، وهي خاضعة لوجهات نظر والخلاف والتوافق ضمن العملية الديمقراطية؟ فالأوراق النقاشية الملكية تطرح للنقاش معالم واضحة للوجهة والغاية، بعيدة عما نراه في كثير من دول المنطقة والعالم: فهي وبوضوح بل وبإصرار تلفظ وترفض خيارات الأنظمة المستبدة والشمولية، وتبني على مبادئ الدستور الأردني النيابي الملكي فتنحو نحو تحديث المنظومة السياسية وصولا إلى حكومات برلمانية منتخبة. ويمكن تلخيص طروحات الأوراق النقاشية حول الغاية أو الوجهة بعنوانين، وحول المسيرة أو الطريق بعنوانين أيضاً. فالغاية تتمثل أولاً بالدولة القوية بقوانينها ومؤسساتها وثانياً بالمجتمع القوي بمواطنيه ومؤسساته المجتمعية والحزبية. والطريق تتمثل أولاً بالتحول الديمقراطي التدريجي والتراكمي، وثانيا بالنظام الملكي كضامن لالتزام كافة الفرقاء بقواعد العملية الديمقراطية. الأوراق النقاشية الملكية شكلت طروحات للنقاش والبلورة والتطوير وليس نهايات.
قد يتفق الجميع على الغاية التي تتمثل في تعزيز الدولة القوية المجتمع القوي، ومن خلال النظام الديمقراطي. أما كيفية الانتقال والتحول الى هذه الحالة الناجزة من حيث السيرورة والسرعة والمتطلبات المسبقة والمخاطر المتوقعة، فهذه تثير الكثير من الأسئلة والهواجس حول مآلات الانتقال الديمقراطي وتبعاته الأمنية والسياسية والاقتصادية. وهذه الأسئلة والهواجس مشروعة ويجب طرحها والتعامل معها والتوصل الى اجابات على الأسئلة والى مبادئ وأعراف متوافق عليها تزيل الهواجس والتخوفات.
ثلاث مقولات وتخوفات مشروعة تطرح في الصالونات السياسية وعلى مواقع التواصل علينا التعامل معها: مقولة الجاهزية (هل الأردن جاهز للتحول الديمقراطي؟)، مقولة الاقتصاد أولاً (أليس الاصلاح الاقتصادي أولى من الاصلاح السياسي؟)، ومقولة المؤامرة (أليس كل ما يطرح تحت شعار التحول الديمقراطي وغيره من التحولات هو مؤامرة تصب في مشروع الوطن البديل؟) نتناول كلا منها هنا باختصار:
مقولة الجاهزية: مقولة مدى الجاهزية تتعلق بشكل رئيسي بضعف الحياة الحزبية وعدم رغبة أو تخوف المواطنين من الانخراط بها. لا شك أن الدول تختلف في جاهزيتها للانتقال الديمقراطي ولذلك أكدت الأوراق النقاشية أن عملية التحول الديمقراطي تراكمية تستغرق سنوات بل وعقودا. ولكن هذا لا يعني عدم البدء وبنموذج وبرنامج زمني يراعي الخصوصية الأردنية. خطورة عدم البدء وبالتالي أن نراوح مكاننا يتمثل في تفاقم “معضلة الثلثين” التي تحدثنا عنها سابقا. وقد انتقد طه حسين رحمه الله قبل حوالي سبعين عاماً موضوع مدى “الاستعداد” حين قال إن الدولة المصرية كانت تدعي آنذاك أنها بحاجة إلى إرجاء الديمقراطية بانتظار محو الأمية ونشر التعليم وتثقيف الشعب. فمع إقراره بأهمية التعليم والتثقيف، إلا أنه ربط الديمقراطية بالممارسة، وقارنها بتعلم الطفل للمشي، فالموضوع ليس نظريا ولا بديل فيه عن البدء والمحاولة والوقوع والعودة إلى الوقوف والمسير مع توفير بيئة تخفف المخاطر وتزيل العقبات وتبني ثقافة الحوار والقبول بالآخر. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الأردن والمغرب، وحسب المؤشرات الدولية، هما من أكثر الدول العربية “جاهزيةً” للتحول الديمقراطي مقارنة مع الدول العربية.
مقولة الاقتصاد أولاً: كثيرا ما نستمع إلى طروحات بأن الهاجس الاقتصادي يتقدم على الهاجس السياسي بالنسبة للمواطن الأردني. وهذا بلا شك صحيح بالمجمل وموثق بدراسات ومسوحات ميدانية متكررة. كما أنه صحيح أيضا وموثق في كل دول العالم التي تعاني من بطالة أو نسب فقر عالية. ولكن علينا ألا نغفل الترابط العضوي بين الملفين. فغالبا ما يتطلب تحديث المنظومة الاقتصادية تحديثا في المنظومة السياسية، والعكس أيضا صحيح.
إن تصوير الأمر على أنه خيار بين الاثنين، أو أولية لأحدهما على الآخر فهو تصوير غير دقيق في أحسن الأحوال. فالإصلاح الاقتصادي يتطلب سياسة وطنية عامة تعكس توافقات سياسية مجتمعية عريضة على الغايات بحيث ينعكس النمو الاقتصادي على فرص عمل وتنمية شاملة وليس إثراءً لفئة على حساب الأخرى. ويتطلب رقابة فاعلة على المال العام وكيفية إنفاقه. ضمان هذا النوع من النمو يحتاج الى خطط واضحة ومساءلة حول النتائج وانفتاح ومكاشفة للرأي العام، وهذا كله يتطلب تحديث المنظومة السياسية. فالإصلاح الاقتصادي والاصلاح السياسي يعززان بعضهما بعضاً. وحتى عندما يتأخر الإصلاح الاقتصادي في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لأسباب خارجة عن السيطرة، (كما حصل في إغلاق الحدود مع العراق سنة 2013 أو جائحة كورونا سنة 2020)، فللمواطن المطلع على الواقع والمشارك في اختيار ممثليه وحكوماته، اما أن يمنح الحكومة مزيداً من الوقت إن شعر بأنها تفعل ما بوسعها، أو أن يستبدلها بأخرى إن شعر بتقصيرها. فإذا كان هو قد شارك في اختيار ممثليه في المجلس النواب وحصلوا على أكثرية لتشكيل حكومة، أو كانوا أقلية فمارسوا الرقابة من خلال المجلس، فسيشعر بقدرة على المساءلة كما بشيء من المسؤولية حول النتائج. وهذه الآلية هي التي تمكن دول كثيرة من تجاوز هزات اقتصادية كبيرة بتغيير الحكومات المنتخبة واللجوء إلى سياسات بديلة، بدون تهديد منظومة الدولة وقواعد العملية السياسية.
مقولة المؤامرة: لا شك أن الأردن تعرض ولا يزل لمؤامرات تسعى الى تصفية القضية الفلسطينية على حسابه من خلال التوطين والوطن البديل. وفي المقابل، فلا شك بأن باستمرار صلابة الموقف الرافض للتوطين والوطن البديل والمساومة على المقدسات متمثلاً باللاءات الثلاث يعبر عن وحدة الأردن قيادة وشعبا في مواجهة هذه المؤامرات. نعم هذه المؤامرات حقيقية وخطرة وعلينا التنبه لها. ولكن الخطورة الأخرى أن نسمي كل شيء مؤامرة، ونخشى من كل خطوة إصلاحية داخلية وفي أي اتجاه، وننعتها بأنها جزء من المخطط وجزء من المؤامرة، وبالتالي نصاب بالشلل والعجز الذي يمنعنا من الحركة ويضعف قدرتنا على التطوير والتحديث وبالتالي منعتنا وقدرتنا على التصدي.
والأخطر حتى من الشلل أن نوظف هذا التخوف المشروع في خطاب كراهية نبثه داخليا يزرع الفرقة بيننا، ويخلق فئة “نحن” و”الآخرين” داخلياً الذين لا يؤتمن جانبهم، وبالتالي الشك حول ولائهم وانتمائهم ومآربهم. وسائل التواصل تؤجج هذه الشكوك وسريعا ما تصنفهم أعداء داخليين، وبالتالي يصبح السؤال “المنطقي” الوحيد: من يوجه الضربة الأولى؟ من يفترس من أولاً؟ هذا السيناريو مفزع، ولم نصل إليه والحمد لله. ولكن دولاً كثيرة من حولنا وفي العالم بدأت بهكذا توجسات تحولت الى خطاب كراهية أفرز خوفا ووفر وقوداً أدى الى تهلكة متبادلة وخسارة جمعية.
لا أقول إن أصحاب مقولة المؤامرة يسعون الى هكذا مصير، ولكن المسار بطبيعته هو الذي يقود الى هكذا مصير. هكذا تبدأ النزاعات الداخلية التي تفضي الى فراغ يغتنمه العدو. إنها النبوءة التي نخشى حصولها ولكن بأفعالنا نصبح أسراها ونحققها وإن بغير قصد. خطاب الكراهية والبحث عن عدو داخلي لن يحمي الوطن، وحدتنا الوطنية الداخلية فقط هي التي ستحميه. ووحدتنا هي الكفيلة بصد مؤامرة الوطن البديل. وأي إضعاف لهذه الوحدة من شأنه خلق البيئة المواتية التي يبحث عنها العدو.
فلنتوافق على أن الأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين، وأن كل من يحمل جواز سفر أردني ورقما وطنيا هو مواطن. ولنتعاهد أن نقف صفاً واحدا، من شمال حدودنا الى جنوبها نذود فيها عن تراب هذا الوطن ونصد أي محاولة ترحيل لأي مواطن فلسطيني من أرض فلسطين. وسيقف بنفس صلابتنا على الجانب الفلسطيني شعب فلسطين بأكمله متشبثاً بأرضه وقضيته.
لا بأس، بل ضروري وحيوي أن نختلف في وجهات النظر. ولكن لنتفق على أن خطاب الكراهية والبحث عن عدو داخلي لن يحمي الوطن. وحدتنا فقط هي التي ستحميه، فلنختلف في وجهات النظر ونتفق في وجهة الوطن ونسير معاً نحو مئويتنا الثانية.
كرئيس وزراء سابق، أنا لا أكتب كمحلل أو مراقب حيادي. فأنا كما غيري من أصحاب الدولة والوزراء والمسؤولين السابقين واللاحقين، حاولنا دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي والسياسي، فاجتهدنا، فأخطأنا هنا وأصبنا هناك، ونتحمل مسؤولية التراكم الذي وصلنا إليه اليوم بما له وما عليه. أما الأهم فهو تقييم واقع الحال واستلهام الدروس والعبر والمضي قدماً. وهذا ما أسعى إليه في هذه المقالات، والله من وراء القصد.

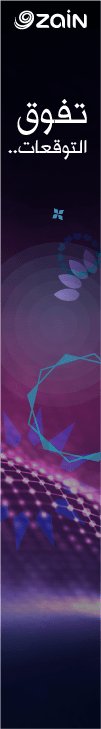
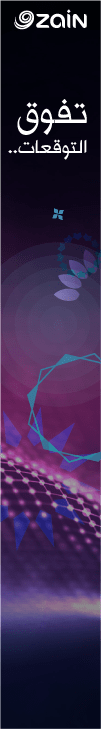

التعليقات مغلقة.