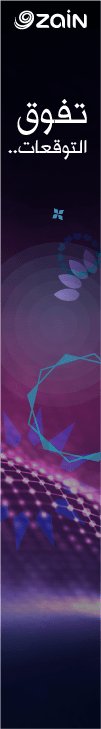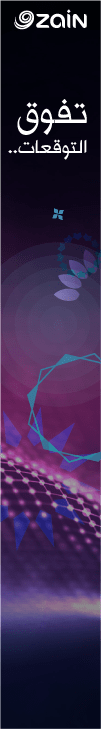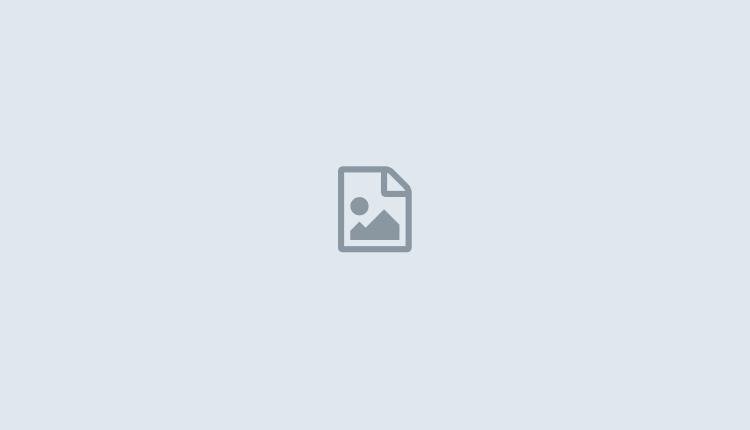بَدو..!
كل يوم، وتحت كل حدَث، ثمة ما يُذكّر بقصة ميسون بنت بحدل الكلبية، صاحبة القصر وبيت الشَّعَر. وقصة ميسون هذه أنها كانت امرأة ذات جمال باهر، حتى إن معاوية بن أبي سفيان أعجب بها وتزوجها، وهيأ لها “قصراً مشرفاً على الغوطة، وزيَنه بأنواع الزخارف، ووضع فيه من أواني الفضة والذهب ما يضاهيه، ونقل إليه من الديباج الرومي والموشى ما هو لائق به”. لكنها جلست ذات يوم في روشنها محاطة بالخضرة والجواري “فتذكرت باديتها، وحنت إلى أترابها وأناسها وتذكرت مسقط رأسها، فبكت وتنهدت. فقالت لها بعض حظاياها: ما يبكيكِ وأنتِ في مُلكٍ يضاهي مُلك بلقيس. فتنفست الصعداء ثم أنشدت:
لَبيتٌ تخفقُ الأرواح فيهِ
أحَبُّ إليَّ من قصر مُنيفِ
وخرقٌ من بني عمّي نحيفٌ
أحب إليَّ من عِلج عَنوفِ
خُشونةُ عيشتي في البَدو أشهى
إلى نفسي من العيش الطريفِ
فلما دخل معاوية، عرَّفته إحدى الوصيفات بما قالت ميسون، فقال: ما رضيَت ابنة بحدَل حتى جعلتني عِلجاً عنوفاً؟ هي طالق ثلاثاً. ثم سيّرها الى أهلها في نجد…”. (علج، يعني مثل “العلوج” الأميركيين في وصف محمد سعيد الصحاف).
تذكر المراجع التراثية هذه القصة –غالباً- مع تعليق يذكر فضائل البداوة والبادية، من قبيل: “البادية أنقى هواء، وأهلها أصحُّ أجساداً، في البادية صفاء ونقاء”. لطيف! ولكن، لماذا نصر على هدر نقودناً على الشوارع والحواضر والتكنولوجيا إذا كان الأصحُّ لأجساد العرب وراحة نفوسهم أن يعيشوا في الفضاء الأجرد، في بيتِ بريّ “تخفق الأرواح (أو الأرياح) فيه؟ ولماذا هذا التوزُّع الممزِّقُ في روحنا بين البداوة والحضارة حتى هذه النقطة في التاريخ؟
كان مما ذكرني بميسون وشعرها، ما سمعته عن جابي مياه، ذهب في أول عمله إلى إحدى الإقطاعيات المحلية التي لا يدفع أصحابها فواتير الماء للدولة. ولما كان الجابي “حنبلياً” في البداية، أصرّ على قراءة العدادات، حتى أدخلوه وجعلوه يرى المسدسات تحت العباءات. فاستدرك وقال إنه جاء فقط للتعارف وشرب القهوة البدوية، وسلّم وخرج لا يلوي على شيء. وذكّر بمسيون أيضاً هذا التناقض الذي لا تخطئه العين بين سلوكنا العصبوي الأثريّ في الشوارع، وبين المظهر الحضري الخادع للعمارات والسيارات. ويذكُّر بمسيون أيضاً كلّ واحد منّا -وما أكثرنا- نملأ الدنيا كلاماً وكتابةً وتنظيراً عن هجرة العصبة إلى الوطن والدولة والتقدم، ثم نذهب مذهب ميسون الكلبية عند أول منعطف، ونستجير لمنفعتنا وانتهازيتنا والاستقواء على جيراننا بالبيت إياه صاحب الريح، ونستريح من البيت المنيف، لأن جدرانه أضعف من بيت العزوة والعصبة!
حتّى لا يتعصب أحد، أؤكدُ إيماني المخلص بأنّ في كلِّ عربيّ بدويٌّا، وأنّ تقسيمة “بدو، وحضر، وفلاحون” تظل اعتباطية لأغراض التصنيف العملي فقط، ولا تلغي الجين العنيد نفسه الموروث في الجميع. وللدليل، ستجد أن كل شجرة عائلة عربية، أينما كان موقعها، تنتهي حتماً إلى قبيلة بقدرة قادر –يفضل أن تكون من اليمن أو الحجاز؟!- كانت لها إبل وسيوف وشاعر. وحتى أكثرنا “تحضراً” ممّن يرتدي سروال “هيب هوب” وطاقية مقلوبة، سيقول: “يا ابن العم”، وهو يتصل بأقاربه من المتنفذين ليجدوا له وظيفة حكومية، ولن ينفعه التنافس الحرّ. وإذا أراد خطبة فتاة، صاح “واتغلباه”، وجمع القبيلة من أطرافها، خاصة أصحاب العباءات والسيارات، وصنع قافلة تغلق الشوارع وحارة المخطوبة. وإذا حضرت المسدسات وأُطلقت العيارات وفُتحت جبهة، فأنعِم وأكرم، وهل العيش إلا ذاك؟! وإذا اختلف مع جاره أو زميله في الشارع، أحصى السيوف والرجال، فإذا اطمئن، صعّد وصهل واستنهض العشيرة، مستعيداً فخار داحس والغبراء.
نعرف ناساً عن قُرب، وآخرين عن بعد، من “وجه صندوق” المثقفين والسياسيين الذين يعرضون أنفسهم بدائل مثالية لتحمل المسؤولية وتطبيق حكم القانون والتحضر والديمقراطية. لكنه إذا باض الحمام على الوتد، ووصلوا فعلاً إلى وزارة أو نيابة، فبالمحاصصة العائلية، أو بأصوات العشيرة. فكيف لا يكون ولاء هؤلاء لهذه؟ في ذروة “الربيع العربي” الطلق، ما نزال نختار “حنين” ميسون وضيقها بالحضارة. ونعود مطلَّقين إلى نجودنا، إلى البيت في مهب الريح وسط العراء، تحت رحمة أيّ هبّة قوية قد تحمله وتتركنا قاعدين على الرمل، ببداوتنا التي بلا تزاويق، مع دِلالنا ورباباتنا!
الغد