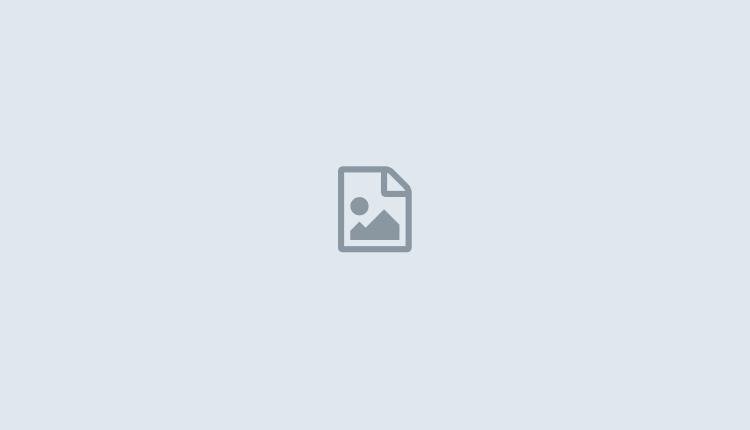تقديس التوحُّش..!
في أوج حركة الاستعمار الغربي للعالم الثالث، تحدث المنظّرون الغربيون عن “التنوير” و”التحضر” كمتعلقات بالمركز الأوروبي، في مقابل “وحشية” و”بدائية” الشعوب المستعمرَة. وتحت هذه العناوين، نفذ الغزاة الإمبرياليون أكثر الممارسات همجية ووحشية في التاريخ. وفي تلك الأوقات، كان الخطاب الغربي متفرداً، في حين كان صوت الشعوب المغلوبة مُسكتاً، ووجودهم نفسه أقرب إلى وجود الأشباح والكائنات البكماء الغامضة. وبعد ذلك، عندما تمكنت هذه الشعوب أخيراً من النطق وسرد حكايتها من خلال كُتابها، بدا الغربيون العاديون مأخوذين بما سمعوه مما أسماه منظر ما بعد الكولونيالية البارز، بيل أشكروفت ومشاركوه: “الإمبراطورية ترد كتابة”.
لعل من أدق التعبيرات عن تقديس فكرة الغزو والهيمنة، ما كتبه الروائي العظيم جوزيف كونراد، على لسان راويه مارلو، في رواية “قلب الظلمة” سنة (1899). قال مارلو الذي عمل في شركة أوروبية تستعبد مواطني الكونغو وتسرق العاج من بلدهم: “الاستيلاء على الأرض، الذي يعني في الغالب أخذها من أولئك الذين لديهم بشرة مختلفة أو أنوف مسطحة أكثر قليلاً من أنوفنا، ليس شيئاً جميلاً عندما تتأمله. لكن ما يعوض ذلك هو الفكرة فقط. فكرةٌ تسكن في خلفيته؛ ليس تظاهراً عاطفياً وإنما فكرة؛ واعتقاد غير أناني بالفكرة – شيء يمكنك أن تقيمه نُصباً، وتنحني أمامه، وتقدم له النُّذور…”.
وبعد قرن كامل، في العام 2002، في مقاله المعنون “الإمبريالية الليبرالية الجديدة،” كتب روبرت كوبر، المسؤول الكبير في وزارة الخارجية البريطانية:
“التحدي الذي يواجه عالم ما بعد الحداثة هو الاعتياد على فكرة المعايير المزدوجة. فيما بيننا، نعمل على أساس القوانين والأمن التعاوني المفتوح، لكننا عندما نتعامل مع الدول الأعتق طرازاً خارج قارة أوروبا ما بعد الحداثة (المتحضرة)، فإننا نعود إلى الأساليب الأكثر قسوة من حقبة سابقة -القوة، الهجوم الوقائي، والخداع، وكل ما هو ضروري للتعامل مع أولئك الذين ما يزالون يعيشون في عالم القرن التاسع عشر (المتوحشين) في كل دولة بذاتها. فيما بيننا، نحافظ على القانون. ولكننا عندما نعمل في الغابة (قلب الظلمة)، فإن ما نحتاجه عندئذ هو استخدام قوانين الغاب… ما نحتاجه عندئذ هو نوع جديد من الإمبريالية، واحد يكون مقبولاً لعالَم حقوق الإنسان والقيم العالمية، والذي نستطيع أن نستشف مخططه مسبقاً: إمبريالية تهدف، مثل كل الإمبريالية، إلى جلب النظام والتنظيم، لكنها تقوم اليوم على أساس المبدأ الطوعي”.
إذن، لم يتغير تكوين التفاعل العالمي على طريقة البشر في أي وقت. والذي يختلف من مرحلة إلى أخرى هو هوية صاحب “التنوير” الذي يمتلك عادة أدوات القوة والإخضاع والخطاب، فيما المستضعفون يعاينون الأضرار. وعلى سبيل المثال، تعقب كثير من المراقبين الغربيين مؤخراً –بكثافة لافتة- جذور المشكلة التي دفعت بالمهاجرين من شمال أفريقيا إلى مهاجمة الصحيفة الفرنسية العنصرية، فقالوا إن الاستهانة بالآخر وإفقاره وإهانته واعتباره همجياً، هي التي تدفعه إلى التطرف (الوحشية). ومن الطبيعي أن الهمجية ستخلف الوحشية وليس التنوير. ويمتلئ التاريخ بقصص تسلي الأباطرة القدامى بجعل المستعبدين يتصارعون بوحشية حتى الموت في الحلبات. إنهم يضعونهم أمام الخيار الهمجي: “أنت أو الآخر”، حتى يصبح القتل بوحشية هو وسيلة الحياة.
المشكلة في قصة “التنوير” و”الهمجية”، هي اعتقاد كل منظومة مصلحية في العالَم بأنها هي الوكيل الحصري للتنوير، وأن كل آخر هو همجي بالضرورة. وعلى الأساس النفعي المحسوب بالورقة والقلم الذي يرشد هذه المنظومات، سينطوي “تنوير” الآخر “الهمجي” على إمكانية جعله منافساً إذا استنار، ولا يعود يقبل بالهيمنة عليه. ولذلك بالضبط، اتخذ “التنوير” غالباً شكل إعدام الآخر أو تقييد طاقاته واستعباده والاستيلاء على موارده بدلاً من تعليمه كيف ينطلق. ومن أجل تطهير “الضمير”، زعم كل أصحاب “التنوير” بهذا المعنى أنهم يضطلعون بمهمة إلهية مقدسة، وأنهم يجلدون الآخر حتى يحرروه من عتمته وضلاله. وما يزال هذا التصور صالحاً في تفسير كل أشكال الهمجية “التنويرية” الحديثة، من معاملة الأنظمة الاستبدادية مواطنيها، إلى معاملة الغزاة الصهاينة للفلسطينيين، إلى حرب بوش وبلير على العراق والعرب، إلى تخريب سورية وليبيا، إلى حرب “داعش” على كل مختلف، إلى صفاقة “شارلي إيبدو” وتعصب مهاجميها. ولا يبدو تقديس التوحش مرشحاً للذهاب!
الغد